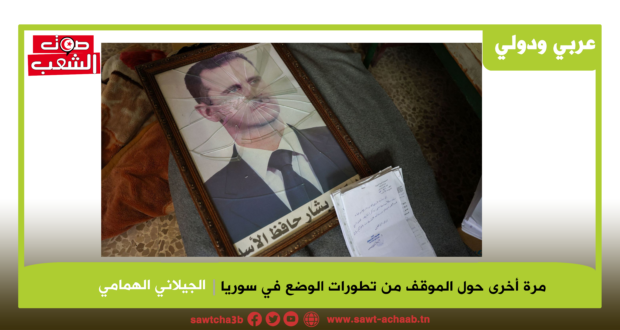بقلم الجيلاني الهمامي
الموقف مما حدث في سوريا دقيق ومن الخطأ بمكان اختزاله في “مع هذا” أو “ضد ذاك“. لقد اندلعت التطورات الأخيرة في سوريا بشكل فجئي وتواترت بشكل سريع وبارتباط بسياقات دولية وإقليمية متشابكة ومعقدة. وهو ما أضفى على هذه التطورات طابعها الخاص الذي يستوجب، عند صياغة الموقف منها، مراعاة تشابك مختلف العوامل والعناصر والمعطيات التي غذتها وحفت بها ورسمت مساراتها. لذلك فإنّ الموقف ليس محكوما حصريا بمنطق ثنائية “بشار الأسد/المعارضة المسلحة” ولا يتمثل، في النهاية، في الوقوف مع هذا أو ذاك من طرفي هذه الثنائية. الموقف أعمق وأعقد وأدق من ذلك بكثير. وبغاية تسليط الضوء على بعض الجوانب من المسألة نحاول فيما يلي توضيح ما يمكن أن يكون موطن التباس في الموقف من الأحداث الأخيرة ونتائجها الآنية وما ستؤول إليه مستقبلا.
حقيقة نظام الأسد
نظام بشار الأسد هو جزء من النظام الرسمي العربي، “يتميز” بكل مميزات وخصائص أنظمة الحكم التي انتصبت في الأقطار العربية منذ خمسينات القرن الماضي سواء ضمن عملية توريث عائلي للحكم في المملكات والإمارات أو نتيجة انتخابات في ما يسمى بالجمهوريات أو نتيجة انقلابات عسكرية كما حصل في مصر والعراق وسوريا.
استلم حافظ الأسد الحكم يوم 16 نوفمبر 1970 إثر انقلاب على نظام نور الدين الأتاسي وصلاح جديد البعثي ضمن ما أطلق عليه “حركة التصحيح في حزب البعث“، وركز على مدى ثلاثين سنة من حكمه نظاما استبداديا منغلقا رزح فيه الشعب السوري تحت الغطرسة والقمع والتعسف. وعند وفاته سنة 2000 تولى ابنه بشار الأسد الذي تم إعداده منذ سنوات للحكم فتقلد منصب الرئاسة شهرا بعد وفاة والده (10 جويلية 2000) في إطار عملية توريث طوعت الدستور السوري الذي تم تنقيحه باتجاه تخفيض شرط سن الترشح على المقاس (من 40 إلى 34 سنة). ومكث في الحكم عن طريق انتخابات رئاسية “فاز” فيها كل مرة بنسب تفوق 95% آخرها كانت سنة 2014 و2021، شككت الأمم المتحدة والعديد من الدول الغربية في مصداقيتها.
لقد تميّز نظام الحكم البعثي في عهد الأسد، الأب والابن، بالاستبداد وقمع المعارضين ومنع الحريات العامة والفردية في ظل نظام الحزب الواحد (حزب البعث) وسطوة أجهزة المخابرات العسكرية والبوليسية جعل من سوريا سجنا كبيرا. ومع ذلك فقد عرفت سوريا في عهده سلسلة من الانتفاضات أغرقت كلها في الدم أشهرها مذبحة جسر الشغور (مارس 1980) ومذبحة حلب (أوت 1980) ومجزرة سجن تدمر (جوان 1980) ومجازر حماه سنتي 1981 و1982.
لم يكن تاريخ نظام آل الأسد لا نظاما وطنيا معاديا للإمبريالية والصهيونية ولا نظاما قوميا وفيا لمبادئ القومية العربية والوحدة. تماما كما لم يكن نظاما ديمقراطيا يتمتع فيه الشعب السوري بالحرية وبالديمقراطية في تسيير شؤونه وشؤون دولته ومؤسساتها. فالعكس هو الصحيح إذ لم يجن الشعب من حكمه غير الفقر والبطالة والبؤس والاحتياج والقمع والتعسف والقهر والتهجير والتشتيت. وقد حاول، أي الشعب السوري، في أكثر من مرة التمرد عليه والإطاحة به ولكنه لم يفلح في ذلك. فسقوط هذا النظام كان حلما يراود السوريين على امتداد فترة وجوده. واليوم وقد فرّ بشار الأسد إلى المنفى في روسيا وتفكك نظامه، وهو ما كان ما يتمناه الشعب السوري، يحق لنا أن نهنئه بذلك على أمل أن يدشن مرحلة جديدة من تاريخه قوامها الحرية والتقدم والرفاه.
وهذا ما لا يقبله البعض أو لا يروق له بحجة:
– أنه حينما يتعلق الأمر بالتحرر الوطني فإنّ رحيل نظام الأسد يصبح خسارة للشعب السوري ولعموم الشعوب العربية وللمقاومة وجبهة الممانعة الخ… في ظرف تتعرض فيه إلى التقتيل والإبادة الجماعية لأنه في مثل هذه الحالات تأخذ مسألة التحرر الوطني في سلم ترتيب الأولويات أسبقية عن بقية قضايا الصراع الطبقي.
– أنه بالنظر إلى طبيعة القوى التي حلت محله هي قوى رجعية وعميلة وجيء بها على ظهر دبابات تركيا وأمريكا والكيان الصهيوني وبتدبير منهم وبرعايتهم ويكون من الأسلم العمل بالمثل التونسي “شد مشومك لا يجيك ما أشوم منه“.
وهي حجج واهية ولا مبدئية ولا تستند إلى أبسط قواعد المنطق، بل ما هي إلا تجسيد لمنطق التعامل البراغماتي مع مسألة جوهرية هي حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار من يحكمها بحرية وعن اقتناع. ومن جهة ثانية فإنّ أصحاب مثل هذه الحجج ينطلقون في تحاليلهم من منطلقات خاطئة ومن تزوير الوقائع الراهنة والتاريخية لتمرير استنتاجات متعسفة ومغالطة كالقول بالتزام نظام الأسد بمسألة “التحرر الوطني” ودعم محور المقاومة والقضية الفلسطينية الخ…
إنّ تاريخ نظام الأسد حافل بالخيانات للوطن وللقضية الفلسطينية من ذلك تسليمه منطقة القنيطرة السورية في حرب 1967 للجيش الصهيوني وامتناعه عن معاضدة القوات الجوية الأردنية في تلك الحرب ثم فيما بعد رفضه دعم القوات الفلسطينية في حرب أيلول 1969 ضد جيش العميل الملك حسين ملك الأردن الأمر الذي كلفه، أي حافظ الأسد، الإقالة من منصبه القيادي في الجيش والحزب. ومن المعلوم أيضا أنه وقف إلى جانب إيران في الحرب العراقية الإيرانية ومدها بصواريخ “سكود” وتولى تدريب قواتها على صنع الصواريخ وشارك بـ 16 ألفا من جنوده في التحالف الثلاثيني في بداية التسعينات لـ“تحرير الكويت” والحرب على العراق. ومما يذكره التاريخ أيضا الدور الذي لعبه نظام حافظ الأسد في لبنان ودعمه لقوات الكتائب المارونية المسيحية ضد منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة حرب الإبادة التي شنها على القوات الفلسطينية في مخيم تل الزعتر في ضواحي بيروت بعد حصار دام خمسين يوما أودت بحياة حوالي 4300 فلسطيني.
أما اليوم فإنّ انتساب نظام بشار الأسد إلى “محور المقاومة” فهو محظ مغالطة وتزوير للحقائق ذلك أنه طوال أكثر من سنة على حرب الإبادة في غزة لم يطلق رصاصة واحدة على الكيان الصهيوني رغم الغارات المتكررة للطيران العسكري الصهيوني على التراب السوري من شماله إلى جنوبه اكتفى جيشه بمحاولات صدها. أما أنّ سوريا كانت تسهل وصول الأسلحة إلى المقاومة في لبنان عبر التراب السوري فلم يكن ذلك من منطلق انخراط نظام الأسد في معركة “التحرر الوطني” وفي “محور المقاومة” بقدر ما كان استتباعا لبنود التحالف الذي نسجه في المنطقة والذي كان له الفضل في بقائه في الحكم. إذ لا يجب أن ننسى أنّ فيالق حزب الله والخبراء العسكريين وضباط “الحرس الثوري الإيراني” هم الذين ساعدوا نظام الأسد على إخماد الثورة في سوريا ثم في هزم المجموعات الإرهابية، تنظيم داعش وجبهة النصرة وهيئة تحرير الشام. ومن هذا التحالف استمدت إيران، مثلها مثل روسيا، “حقها” في إقامة قواعد عسكرية والتسرب إلى مفاصل الدولة والاقتصاد في سوريا وتنظيم قنوات تسليح حزب الله في لبنان. لذلك كان القبول بأن يكون التراب السوري معبرا لمرور الأسلحة والبضائع إلى لبنان من باب الترتيبات التي أملاها التحالف مع إيران وروسيا، كما كان القبول باحتضان الفصائل الفلسطينية من باب توظيفها في الخطة الدعائية “القومية” للنظام البعثي ولكن أيضا للحفاظ عليها كعناصر مناوشة في خطة تعديل موازين القوى بين القوى الإقليمية بشكل عام وبالتحديد بين إيران من جهة والكيان الصهيوني من جهة ثانية.
وخلاصة القول فإنّ التعويل على القوى الخارجية، بالشكل الذي اتبعه نظام الأسد في علاقة بإيران وروسيا، لا يمت لمسألة “التحرر الوطني” بصلة بقدر ما كان يجسد خضوعه لهذه القوى الامبريالية (روسيا) والقوى التوسعية إقليميا (إيران) مقابل مساعدته على البقاء في سدة الحكم.
إنّ التحرر الوطني لا يتم بالاعتماد على القوى الخارجية التي تقيم على التراب الوطني قواعد عسكرية وتقتطع منه مناطق نفوذ تتصرف فيها كما لو كانت مستعمراتها الخاصة. ولهذا السبب لا يمكن الدفاع عن نظام بشار الأسد على أنه كان إلى جانب قضية “التحرر الوطني” في بلاده أو في فلسطين أو لبنان. والعكس هو الصحيح لأنّ في رحيله فرصة ستتيح للشعب السوري موضوعيا عوامل مهمة للتقدم فعلا في نضاله من أجل التحرر الوطني والديمقراطية والتقدم.
من جحيم نظام الأسد إلى جحيم آخر
هذا من جانب، أما فيما يخص حجة “أنّ القوى التي افتكت السلطة هي قوى غارقة في الرجعية والعمالة لأمريكا وتركيا والكيان الصهيوني” مدعاة للقبول ببقاء بشار الأسد على الأقل لمواقفه الإيجابية في صالح المقاومة وضد الامبريالية والصهيونية وتركيا، فهي أيضا حجة في ظاهرها “ثورية” ومتجذرة (مناهضة للتدخل الامبريالي الصهيوني الرجعي وللمجموعات الإرهابية العميلة) ولكنها في جوهرها ضعيفة ومتهافتة وناجمة إما عن خلط فكري وسياسي وعن قصور نظر وإما عن نزعة تبريرية انتهازية.
إنّ الانتصار المبدئي لحق الشعب السوري في التحرر من ربقة الحكم الرجعي والاستبدادي لا يحتمل السقوط تحت سقف المفاضلة بين رجعي وأقل رجعية. لأنّ مصلحته بقدر ما تتعارض مع وجود المجموعات الإرهابية (النصرة وهيئة تحرير الشام الخ…) لأنها رجعية وعميلة واستبدادية تتعارض أيضا مع نظام بشار الأسد لأنه – وكما تأكد من خلال أكثر من نصف قرن من وجوده في الحكم – لا يقل عنها رجعية وفسادا وعمالة واستبدادا.
إنّ الاستبشار بسقوط نظام بشار الأسد باعتباره يمكن أن يكون مقدمة لتحرر الشعب السوري الشقيق وتقدمه لا يعني في المقابل من ذلك ترحيبا بالنظام الذي سيحل محله، نظام المجاميع اليمينية المتطرفة الإرهابية عملاء تركيا والامبريالية الامريكية والصهيونية، ولا قبولا بالطريقة التي جاؤوا بها إلى الحكم بتدبير من نظام أردوغان وأمريكا والكيان الصهيوني.
فالاستبشار برحيل بشار الأسد هو شعور مشروع لجماهير الشعب السوري الذي ذاق الويلات على يديه كما سبق أن بيناه وهو شعور مشروع لدى كل المتعاطفين مع الشعب السوري والذين انتصروا لحقه في الحرية والديمقراطية سواء كانوا عربا أم غير عرب. لكم تمنينا أن يكون سقوط نظام الأسد الاستبدادي نتيجة ثورة شعبية مستقلة تمام الاستقلال عن الامبريالية والصهيونية والقوى الرجعية العربية العميلة وعن التيارات الظلامية والارهابية، جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام وغيرها. ثم لكم تمنينا أن يكون سقوطه نتيجة ثورة مظفرة بقيادة مناضلين تقدميين وديمقراطيين من أبناء الشعب السوري. لكن وللأسف كانت الحقيقة غير ذلك. فقد تم الانحراف بانتفاضة الشعب السوري سنوات 2011 و2012 إلى الاقتتال الأهلي جراء تدخل القوى الرجعية العربية (قطر وبقية بلدان الخليج) والامبريالية بما في ذلك روسيا والصهيونية والقوى الهيمنية في المنطقة (تركيا وإيران). وقد أخذ الصراع على السلطة في سوريا على امتداد السنوات الماضية أبعادا أخرى لعبت فيها المخططات الاستعمارية والاستعمارية الجديدة أدوارا أساسية ضمن لعبة دولية معقدة حولت سوريا إلى واحدة من أهم مسارح الصراع الامبريالي في العالم. وفي هذا السياق تندرج عملية إزاحة الأسد كجزء من خطة إعادة تشكيل المنطقة وفق مقتضيات المصالح الامبريالية وموازين القوى. وقد تم تدبيرها بعد أن تخلت عنه القوى التي كانت تسنده بمقابل (قواعد عسكرية واحتلال مساحات مهمة من التراب السوري) وبعد أن تم إعادة تسليح وتنظيم المجموعات الإرهابية وفسح المجال أمامها للزحف على المدن السورية وصولا إلى دمشق.
لا شك في أنّ المخطط الذي تم طبخه من مدة كما كشفت المعطيات الأخيرة يراد منه تحقيق سلّة من الأهداف منها ما يتعلق بتسوية جوانب من الصراع الامبريالي وتقسيم مناطق النفوذ (أكرانيا مقابل سوريا) ومنها ما يتعلق بخارطة منطقة الشرق الأوسط الجديدة وتعديل موازين القوى فيها بين القوى الجهوية (تركيا وإيران والكيان الصهيوني). ويمثل الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا معبرا لهذه التسوية الجديدة وتمثل المجاميع الإرهابية التي تم ترويضها وجيء بها لخلافة بشار الاسد (النصرة وهيئة الشام الخ…) لتكون الأداة في خدمة مخططات المرحلة القادمة. لذلك فإنّ النظام الجديد علاوة على أنه سيكون نظاما عميلا على المكشوف للإمبريالية وفي خدمة استراتيجية الكيان الصهيوني التوسعية بدعم كامل من الامبريالية الأمريكية والغربية ومطامح تركيا الإقليمية والمساعي لإعادة رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط فإنه سيكون أيضا نظاما استبداديا منغلقا ومعاديا للحرية والديمقراطية وسيعاني الشعب السوري في عهده مرة أخرة الويلات في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
لا هذا ولا ذاك
إنّ اتخاذ موقف مؤيد لسقوط بشار الأسد وفي نفس الوقت رافض للنظام الجديد ليس من باب الجلوس على الربوة كما يدعي البعض وإنما هو تعبير عن الموقف المبدئي المتماسك من حق الشعب السوري في التخلص من نظام الأسد وإقامة نظام جديد وطني وديمقراطي قولا وفعلا. فالشعب السوري ليس قدره أن “يتخندق” بالضرورة في أحد الخندقين، إما مع بشار الأسد أو مع “جبهة تحرير الشام“. بل بالعكس لا يتم خلاصه بالسقوط تحت ربقة نظام استبدادي رجعي جديد هروبا من جحيم نظام بشار الأسد كما لا يكمن خلاصه في القبول طواعية بالخضوع لنظام بشار الاستبدادي بدعوى أنه منخرط في “محور المقاومة” وما إلى ذلك أو هروبا من نظام المجموعات الإرهابية. إنّ خلاص الشعب ليس في استبدال سجن بسجن وتحرر الأوطان لا يمكن أن يكون بتفضيل مستعمر على آخر. فعين الصواب إذن أن يقول الشعب السوري ومعه كل أنصار الحرية والاستقلال في الوطن العربي وفي العالم لا لبشار الأسد وفي ذات الوقت لا للمجاميع الإرهابية صنيعة الامبريالية والصهيونية.
صحيح أنّ الجماهير الشعبية الغاضبة في سوريا كانت أطلقت حركة الاحتجاج سنة 2011 ونادت برحيل بشار الأسد ولكنها لم تكن على أتم الاستعداد للمضي قدما بالانتفاضة حتى تحقيق أهدافها كما لم تكن قادرة على حماية تلك الانتفاضة من قمع النظام ومن توظيف القوى الخارجية والمجموعات الإرهابية التي تم زرعها في سوريا من أجل حرف الثورة عن مسارها السليم. لكن اليوم وفي غياب آلة القمع الرهيبة التي جندها بشار لإخماد انتفاضة سنة 2011 تتوفر للشعب السوري وقواه التقدمية والديمقراطية فرصة لإحياء حركة النضال الوطني والديمقراطي وإعداد شروط الانتفاضة الظافرة ضد الحكام الجدد والقوى الامبريالية والصهيونية والرجعيات في المنطقة.
جيلاني الهمامي
تونس في 18 ديسمبر 2024
 صوت الشعب صوت الحقيقة
صوت الشعب صوت الحقيقة